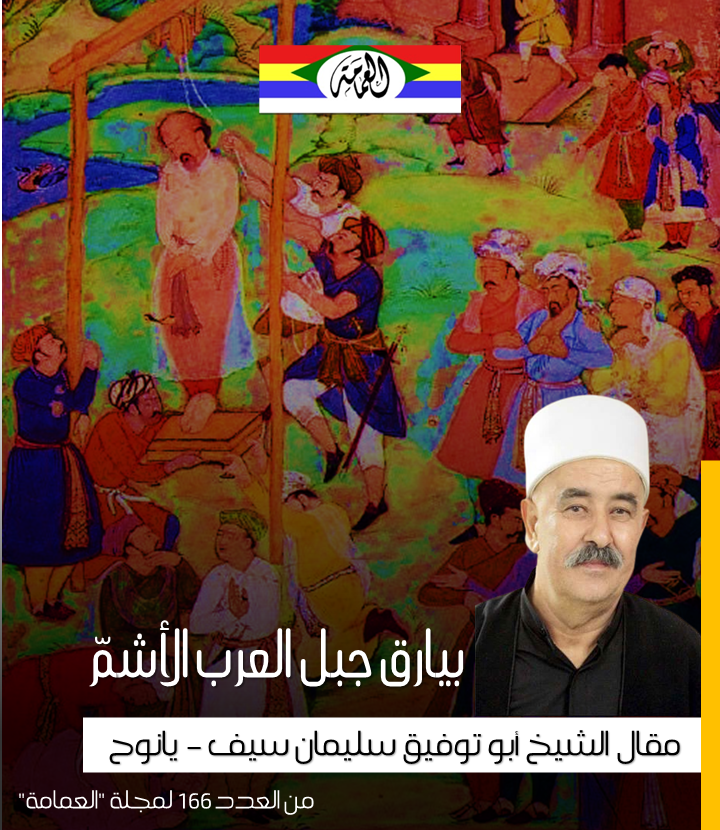مولده في بقعة من بقاع فارس الجميلة العريقة، الغنيّة بخيرات أرضها، وثمار عقول أبنائها، وفي ضحى العصر الذّهبيّ للتّصوّف، في مطلع عام 244 ه (858م) وُلد الحسين بن منصور الحلّاج، في بلدة “تور” في الشّمال الشّرقيّ من مدينة البيضاء.
وتُقدِّم لنا دائرة المعارف الإسلاميّة روايتيْن متناقضتيْن عن نسبه، فالرّواية الأولى تصعد به إلى أبي أيوب الأنصاري الصّحابيّ الجليل، وبذلك تجعله عربيًّا خالصًا. وتقول الرّواية الثّانية: “إنّه حفيد مجوسي من أبناء فارس. والرّواية الّتي تنسبه إلى الأنصاري لم تثبَت تاريخيًّا، ولم يقُل بها مؤرّخ عربيّ، فإجماع رجال التّاريخ، على أنّه فارسيّ الأصل، كما هو فارسيّ المولد.
يقول ابن كثير: “هو الحسين بن منصور بن محمي الحلاّج أبو مغيث، ويقال أبو عبد الله، كان جدّه مجوسيًّا، اسمه (محمي) من أهل فارس من بلدة يُقال لها البيضاء، ونشأ بواسط، ويقال بتستر”
ويقول المستشرق ماسنيون: “إن البقعة التي وُلد فيها كانت من أعظم مناطق النّسيج في الإمبراطوريّة الإسلاميّة، وإن والده كان من عمّال النّسيج، ولهذا سُمّي حلّاجًا، وهو استنتاج فكريّ من “ماسنيون” لم يقم عليه من التّاريخ شاهدًا أو دليلًا.
أمّا الرّواية التّاريخيّة الّتي أوردها ابن خالكان وفي وفيّات الأعيان فتروي عن ضُميره بن حنظلة السمّاك قال: “دخل الحلّاج واسط وكان له شغل، فأوّل حانوت استقبله كان لقطّان، فكلّفه الحلّاج السّعي في إصلاح شغله، وكان للرّجل بيت مملوء قطنًا، فقال له الحسين: اِذهب في إصلاح شغلك، فإني أعينك على عملك، فذهب الرّجل، فلمّا رجع رأى كلّ قطنه محلوجًا وكان أربعة وعشرين رطلًا، فسُمّي من ذلك اليوم حلّاجًا ولازمته هذه الكنية طوال حياته”.
وقد أورد ابن كثير أيضًا هذه الرّواية، وأضاف إليها رواية أخرى تقول: إن أهل الأهواز أطلقوا عليه هذه التّسمية لأنّه كان يكاشفهم بما في قلوبهم فسمّوه “حلّاج الأسرار”.
وبعد مولد الحلّاج بقليل، اضطربت أحوال والده الماليّة، فرحل من بلدة “تور” إلى مدينة “واسط” ينشد العمل في ميادينها الاقتصاديّة الكبيرة. وكانت واسط مركزًا من مراكز الإشعاع الفكريّ والرّوحيّ في فارس، أسّس بها الأشاعرة مدرستهم الكبرى، وأوجد فيها العلّامة أبو علي الجّبائي، نشاطًا ثقافيًّا، وتيّارًا علميًّا حرًّا، يخضع كلّ شيء لمنطقه وطرائفه.
كما أقام بها الحنابلة مدرسة للقرّاء، ومعهدًا للحديث، واتّخذوا من مساجدها مقاعد للبحث والدّرس، والجدل والحوار.
وفي هذا الجو العلميّ الحرّ الحيّ نشأ الحلّاج ولفت إليه الأنظار منذ طفولته، بذكائه المتوقّد الّلمّاح، وشفافيّة روحه، وتفتُّح قلبه، وحبّه وإقباله على ينابيع العلم والمعرفة، حتّى ليحدّثنا تاريخه، أنّه قرأ القرآن الكريم على أعلام القرّاء في عصره، وحفظه وجوّده، وهو في العاشرة من عمره، وتعمّق في فهم معانيه، تعمُّقًا ليس من طبيعة الطّفولة الغضّة.
كما اشتهر بالإرادة القويّة الموجّهة، والرّياضيّات والمجاهدات الرّوحيّة الشّاقّة والزّهد فيما يقبل عليه لذاته من شؤون الحياة، ولهو الطّفولة، والاستغراق الكامل في الصّلاة والتّأمّل والتّعلُّق بالدّراسات الّتي تتناول المعرفة الرّوحيّة وما تحتوي عليه هذه المعرفة من أنوار وأسرار.
وأقبل الحلّاج بكلّ ما في قلبه من أشواق، وما في روحه من إشراق على علوم عصره من فقه وتوحيد وتفسير، وحديث، وحكمة، وتصوّف.
ولكنّه كما يقول ماسنيون: “سرعان ما راح يبحث عن المعنى الرّمزيّ الّذي رفع دعاء الرّوح إلى الله.
كان الحلّاج يحسّ في أعماقه دائمًا تلهُّفًا واشتياقًا إلى معرفة أدقّ وأوثق ممّا يقرأه في صفحات الكتب وممّا يستمع إليه في دروس العلم والعلماء، معرفة تُدنيه وتقرّبه من الله، وتمنحه المعراج الذي تصعد عليه روحه إلى هداه. كان يحسّ أنّ لروحه عند الصّفاء والنّقاء، سيمات ملهمات، تترقرق فيها معانٍ مشرقات، وأنّ قلبه عندما يأخذه الوجد الإلهيّ، والحبّ الرّبّانيّ، تتفتّح فيه منافذ يطلُّ منها على ملكوت رائع الجلال والبهاء، تلتمع في آفاقه حقائق أعلى وأسمى ممّا يتجادل فيه النّاس ويتخاصمون.
وإذن فليعمل الحلّاج على أن ترتفع روحه بالحبّ ارتفاعًا يجعلها أهلًا لهذه الحقائق الّتي يهبها الله لمن ارتضى من عباده، واصطفى من خلقه.
وانقطع الحلّاج عن دروسه، وأقبل على ملكوت السّماء والأرض يقلّب وجهه في آفاقهما، ويتأمّل أسرارهما، ويقرأ بين سطورهما الخفيّة أسرارًا وأسرارًا. وعكف على روحه وقلبه، بالتّصفية والمجاهدة، حتّى أعطيا كنوزهما، وتفجّرا معرفة ونورًا.
ونذر نفسه لربّه سبحانه، وأقبل عليه بكلّ ذاته، وقد اشتعلت أحاسيسه بالوجد، والتهبت عواطفه بالحبّ، انّه يستهدف ارتباط قلبه بالله، وقرّب روحه منه، قربًا يفنى فيه كلّ شيء، ليبقى له بعد ذلك كلّ شيء. إنّه فناء الخالدين بربّهم، وهو فناء وخلود، لا يعرفه إلّا الأُفق الصّوفيّ، وأخذ الحلّاج نفسه بهذا المنهج أخذًا عنيفًا قاسيًا، وألزم نفسه به طوال حياته حتّى غدا طابعه الّذي تشكّل به وجوده المادّيّ والرّوحيّ. ولقد سُئل عن المريد الصّادق فقال: “هو الرّامي بقصده إلى الله عزّ وجلّ، فلا يعرّج حتّى يصل”. وهي كلمة تصوّر لنا منهج الحلاج وهدفه الّذي عاش له وبه، لقد رمى بقصده إلى الله سبحانه وتعالى، وسخّر كلّ ملكاته العقليّة والروحيّة لتحقيق هذا الهدف، بل اتّجه بكلّ أذواقه ومعارفه إلى آفاق هذا المعنى.
فكلمة التّوحيد، وهي السّطر الأوّل في كتاب الإسلام، لا تكون صدقًا وحقًّا كما يقول الحلّاج، إلّا إذا عِشنا وتذوّقناها، وفنينا في معناها، حتّى كأنّنا حين ننطقها نسمعها من الله جلّ جلاله، وحينئذٍ تنبثق في شغاف القلب، وعين الوجدان ويموج كلّ شيء بالجلال والنّور والمعرفة.
والقرآن الكريم كلام الله فيجب على المؤمن أن يتذوّق حقائقه تذوّقًا روحيًّا، وأن تتمثّل فيه هذه الحقائق تمثُّلًا عمليًّا إيجابيًّا.
ويمشي الحلّاج بهذا الفهم خطوات حتّى يقول: “إنّ المؤمن الصّادق يصل به الأمر حتّى تكون “بسم الله” منه بمنزلة “كُن” من الله سبحانه، أيّ أنّ “بسم الله” منه، لها من القوّة والأثر ما لكلمة “كن” من الله سبحانه. ومن كلمات شبابه الّتي تصوّر لنا منهجه قوله: “حقيقة المحبّة قيامك مع محبوبك بخلع أوصافك والاتّصاف بأوصافه”.
إنّها البذرة الّتي يستخرج منها فلسفة الحلّاج في مقام الفناء!! ويقول الحلّاج: “مَن لاحظ الأعمال حجب من المعمول له – الله-، ومَن لاحظ المعمول له حجب عن رؤية الأعمال.
وهذه الصّورة المثاليّة السّامية الّتي تصدرها لنا تلك الكلمة، سنجدها بصورٍ أكمل وأسمى في جهاد الحلّاج وتضحياته.
تلك بعض خواطر الحلّاج القلبيّة والرّوحيّة، وهو في مطلع شبابه قبل أن يسلك المنهج الصّوفيّ على شيوخه، وقبل أن ينتظم في المدرسة الرّوحيّة العالميّة، مدرسة التصوّف، الّتي كانت تهيمن على العراق وفارس خلال القرن الثّالث الهجري.