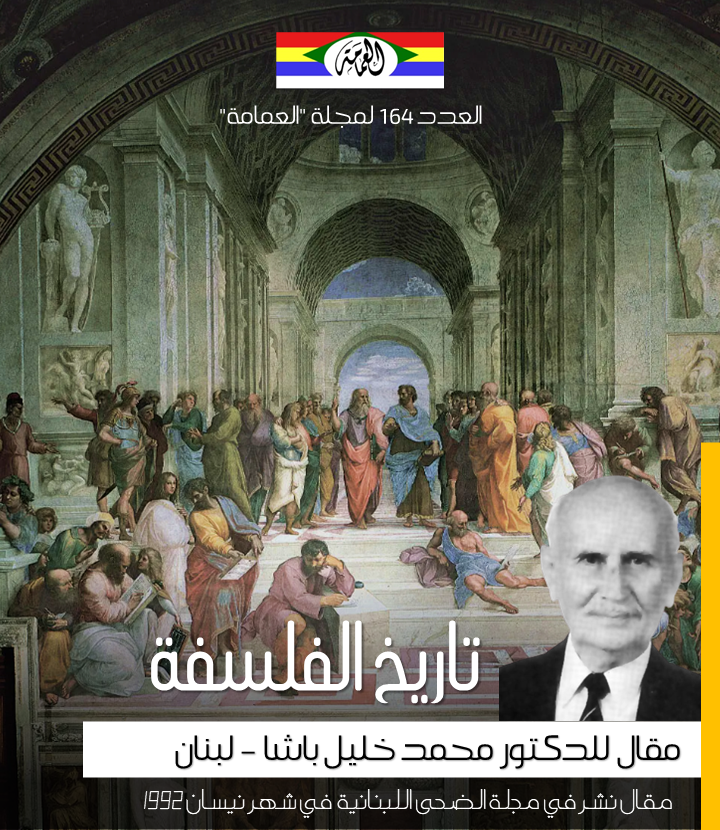ازدهرت العبقريّة الإغريقيّة ما بين بدء الحروب الماديّة وقيام السيادة الرومانيّة، أي من سنة 480 ق.م حتى سنة 200 أي من سقراط إلى أرسطو، ففي خلال هذه القرون الثلاثة تحقّقت جميع إمكانيات العبقريّة اليونانيّة، وقوى الفكر الإنسانيّ، فاستحقّت المجهودات اليونانيّة أن تسمّى المعجزة الهلانيّة.
فللفلسفة اليونانيّة في الحضارة الإنسانيّة أثر بالغ، نلمسه في الفلسفة العربيّة، فقد تناولها الفلاسفة العرب بالشرح أو بالنقد أو بكليهما معًا، وزادوا عليها الكثير لكي تتّفق وعقليّة الشرق، وخصوصًا مع الإسلام. فنرى الكندي، أوّل فلاسفة العرب يأخذ بمذهب المشّائين، ويوجِد للفلسفة ألفاظًا عربيّة، فلُقِّب بفيلسوف العرب. ويأتي بعده الفارابي الذي قال عنه ابن سبعين إنه أفهم فلاسفة الإسلام، فأخذ بفلسفة أرسطو في المنطق والطبيعيّات ومبدأ ما بعد الطبيعة، وأخذ بفلسفة افلاطون في الأخلاق والإلهيّات، ولم يكن في الحقيقة مشّائيًّا، ولا رواقيًّا، ولا أفلاطونيَّا فقط، بل كان يمثّل كل ذلك في وقت واحد، وكان مؤمنًا بوحدة الفلسفة. وجاء بعده ابن سينا الطبيب الفيلسوف، فأخذ من الفلسفة اليونانيّة أشياء، ومزجها بحكمة الشرق، واختطّ لنفسه طريقة خاصّة في التفكير كما وصفه “رينان”.
إن ما ذكرته إلى الآن ليس فيه أي جديد، وهو يملأ بطون الكتب، ولا خلاف حوله، ولا اعتراض عليه، فبصمات الفلسفة اليونانيّة عمّت الشرق والغرب، وليس لي ولا لأحد من الناس أن ينكر العبقريّة اليونانيّة، لكن لي على المؤرّخين الأوروبيين عتبًا كبيرًا يصل إلى حدّ اللوْم، وأحيانًا إلى حدّ الاتّهام، بل الأنانيّة والاستكبار اللذين أزلّا كثيرين منهم عن طريق النزاهة والرؤية الموضوعيّة.
إني لا أرغب، بهذا البحث المقتضب، في أن انتقل إلى الجهة المقابلة لتفنيد ما كتبوه، لأن المجال هنا لا يتّسع لمثل هذا الإسهاب، كما أنني لست رائدًا في إثارة القضايا الواردة فيما يلي، فقد سبقني إليها عدّة أشخاص، لكن الهمّة فترت، النّأمة خفتت، ولم تتحقّق الغاية، فكان مفيدًا أن أكتب هذه السطور لكي أعيد الموضوع إلى بهرة الضوء، ولعلّ أحدًا من ذوي الاختصاص، وخصوصًا الذين يعلِّمون تاريخ الفلسفة في جماعتنا، يبادر إلى الإسهاب في درس مواضيع هذا البحث، وتقديم البراهين لإثباتها:
أوّلًا: المعجزة اليونانية لم تُخلق من العدم:
معظم مؤرّخي الفلاسفة في أوروبا يزدهون كثيرًا بالمعجزة الهلانيّة، ويعزون إليها وحدها دون سواها الفضل في قيام الحضارة في الشرق وفي الغرب، وكأنّه لم يكن قبلها، ولا أتى بعدها شيء ساعد على قيام هذه الحضارات، وكأنّما هي إبداع متكامل، ولا تدين لأحد بوجودها، ولم تكن لها سابقة ولا لاحقة.
ومع أنّهم ذكروا أن كلًّا من الفلاسفة أخذ عمّن سبق، فإنّ أنظارهم بقيت مشدودة إلى فترة الازدهار في القرون الثلاثة التي أشرتُ إليها، وأغضّوا أو تغاضوا عن أن يذكروا بالفضل الفلاسفة السالفين، الذين استخرجوا من الحضارات السابقة، السومريّة والمصريّة والبابليّة والأكاديّة والأشوريّة والفارسيّة والفينيقيّة، محاصيل وضعوها بين يديّ من غربلها ونقّاها ونظّمها فكانت ما أطلق عليه بعدئذٍ اسم المعجزة اليونانيّة. أو ليس عجيبًا أن عالمًا كبيرًا مثل برتراند رسل يقول: ليس في التاريخ كلّه ما يثير الدهشة كالظهور المفاجئ للحضارة اليونانيّة، وهو ما لا يمكن تعليله.
إن القول بالظهور المفاجئ للفلسفة اليونانيّة خلف محض، ويخالف الحقيقة، لأن لا شيء يوجد من العدم، وخصوصًا ما كان بحجم الفلسفة، وباتّساعها وشمولها، فما من بحث في شتّى أدوار الحياة وأطوارها، فيما هو معقول أو غير معقول، فيما هو لطيف أو كثيف، فيما هو عقل أو روح، أو نفس أو جسد، إلّا له صلة بالفلسفة اليونانيّة.
لا أستطيع أن أصدّق أن برتراند رسل يؤمن حقًّا بأنّ الفلسفة اليونانيّة وُلدت فجأة من العدم. إنه يعرف أن العدم لا يولد إلّا العدم، كما قال ديموقريطس، وأن كل ما هو موجود لا بدّ من أن يكون له أصل أو جذع، أو جذور نما منها، أو على الأقلّ بذور انتشت فأخرجت نباتًا سويًّا.
ويقول محمد يوسف موسى في مقدّمته لترجمة كتاب: الفلسفة في الشرق” للمستشرق “بول ماسون أورسيل” ما معناه: لبث الناس زمانًا لا يشكّون في أن الفلسفة قد نشأت أوّل ما نشأت في “أيونيا” المستعمرة التي أسّسها مهاجرو اليونان الأوائل في آسيا الصغرى، واستمرّ هذا الاعتقاد ينمو ويستقرّ في الأذهان كأنّما هو حقيقة لا ريب فيها، يزكّيها عوامل، منها استعلاء المؤرّخ الغربي وغروره، واعتقاد نفسه خير الناس، واستخذاء الشرقي وظنّه السوء بنفسه، ذلك لأنّ للقوّة أثرها في قلب القوي والضعيف على السواء.
وهذا الاعتقاد على غلوّه أو خطئه، له أنصار كثر في الغرب ومن العجب أن يكون له أنصار كثر في الشرق أيضًا.
ثم يستدرك ويقول: إنّ الحقّ لم يعد نصيرًا، رضي الآخرون أم غضبوا، ويورد ما قال الدكتور غوستاف لوبون في كتابه “الحضارات الأولى” “Premieres Civilisations” إن الناس كانوا حتّى الآن يعتقدون أن اليونان غير مدينين في معارفهم لأحد سبقهم، لكن هذا القول عاد لا يؤخذ به اليوم لأن الحضارة القديمة، وإن كانت قد نشأت وترعرعت في الشرق، وفي الوقت الذي لم يكن فيه في اليونان غير جهلة وبرابرة كانت في الشرق حضارات زاهية زاهرة.
والمستشرق الكبير بول ماسون أورسيل خصّص كتابه المشار إليه أعلاه لمعالجة هذا الموضوع، فانتقد التفكير الأوروبي، ثم قال ما ملخّصه أنه لا يوجد في هذه الأيّام أحد يستطيع الاعتقاد أن اليونان وروما وشعوب أوروبا ، في العصور الوسطى والحديثة، هم وحدهم دون سواهم أرباب التفكير الفلسفي، ففي مواطن أخرى من الإنسانية سطعت أنوار متألّقة مُشعّة ، وبما أن هذه المواطن لم تكن منفصلة بعضها عن بعض، لذلك وجب الاعتراف بأنّ تفكير الغرب لا يكتفي بنفسه، بل يجب إعادة وضعه في وسط إنسانيّ، لأنّه لم يكن قطّ يومًا منفصلا عن العالم، لأن التاريخ الصحيح هو وحده التاريخ العالمي.
وهذا الوسط الذي يشير إليه ماسون أورسيل هو بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط وما جاورها، وهو ما أطلق عليه اسم “أوراسيا” أي الجامع بين “أوروبا وآسيا”، فقد تجمّعت هناك روافد حضارات قديمة شتّى، وفي هذا المهد نشأ المفكّرون اليونان الأوائل مثل “طاليس” و”أورفيه” و”فيثاغوروس” و”هيراقليطس” و”وانكسيمنس”، ومن مجهود هؤلاء وأمثالهم نشأت الحضارة المسّينية والاخائيّة والكريتيّة والدوريّة، فتعاقبت على اليونان التي سيطرت على ما جاورها، وامتزجت عن طريق البرّ والبحر ، بحضارات أخرى، فتقدّمت تقدُّمًا سريعًا وصل بها إلى القمّة، وولد ما سُمي بعدئذٍ بالمعجزة اليونانية.
ويقول الدكتور خليل الجر وحنا الفاخوري في تاريخهما: إن ما يسمّيها المؤرّخون “بالمعجزة اليونانيّة” ليس معجزة بكل معنى الكلمة، فقد أخذ الإغريق كثيرًا عمّن تقدّمهم، لكن عبقريّهم النادرة عرفت كيف توحّد بين العناصر المتباينة، وتسكبها في مذاهب فلسفيّة كان لها الفضل الأوّل في توعية الفكر الإنساني.
وإني بالمناسبة ألفت النظر إلى قول سقراط نفسه: ليس عدلًا أن نطري فقط على من نتفق معهم في الرأي، بل يجب أن نطري على غيرهم أيضًا لأنّ هؤلاء شاركوا أيضًا في بناء صرح العلم وساعدوا على تنمية قوّتنا الفكريّة.
وهذه الحقيقة يعرفها مؤرّخو الفلسفة الغربيون بلا شكّ، لكنّنا نريد أن يكون لهم شيء من التواضع يحملهم على إعلانها، بروح النزاهة والتجرُّد المفروض وجودها عند كلّ مؤرّخ، ولا نريدهم أن يبخسوا اليونان حقّهم ، فالعبقريّة اليونانيّة أخذت كلّ ما تخلّف من تراث الحضارات السابقة، بغثّه وسمينه، وبحقائق أوهامه ، وبقصصه وأساطيره، فدرست ومحّصت وغربلت، ووضعت للفلسفة أسسًا وقواعد، وهذا عمل بحدّ ذاته جبّار يستحقّ تسميته بالمعجزة اليونانيّة، شرط ألّا يذهب الغرور بأصحابه إلى أبعد من ذلك، وخصوصًا أنّه لم يبقَ من هذه المعجزة بين أيدينا إلّا الوشل.
ثانيًا الفلسفة العربية:
سمعت الكثيرين يردّدون ما قال به بعض المؤرّخين الغربيين، وهو أن الفلسفة لا وجود لها عند العرب، وأن كلّ ما لديهم إنّما هو مأخوذ عن اليونانيّة، بفضل الترجمات التي بدأت في نحو القرن التاسع الميلادي، وازدهرت بعدئذٍ وخصوصًا في عصر المأمون.
ليس هذا صحيحًا كلّه، ولا باطلًا كلّه، بل فيه من كلّ منهما شيء.
كلمة فلسفة لا وجود لها في العربيّة، بل هي تعريب “فيلوصوفيا” اليونانيّة، ومعناها محبّ الحكمة، لكنّ هذا لا يعني أنّ العرب لم يعرفوا الفلسفة، إنهم عرفوا كثيرًا عن الأفكار الفلسفيّة تحت اسم الحكمة أو ما يشابهها، لأنّ العرب الجاهليّة كانوا على اتّصال وثيق بحضارات العالم، وأن الجزيرة العربيّة كما يقول الدكتور جميل صليبا والدكتور خليل الجر والدكتور علي زيعور وغيرهم كانت قبل الإسلام مسرحًا لكثير من التيّارات الفكريّة، والعقائد الدينيّة، وأنّه كان لأهل الجزيرة معارف فلكيّة وطبيعيّة وأساطير شعبيّة وحِكم وأمثال وأشعار، وكانت ثمّة عقائد فطريّة كعقائد الطبيعيين والجبريين ومنكري القيامة والحساب والجنّة والنار، استقت منها الفلسفة اليونانيّة. وعندما تُرجمت كتب أفلاطون وأرسطو وغيرهما من كتب الفلسفة إلى العربيّة، أخذ الفلاسفة العرب كثيرًا من هذه الفلسفة، فتبعوا بعضها، وخالفوا بعضها ونقدوهم ، وحاولوا التوفيق أحيانًا بين ما وقع عند الفلاسفة من اختلافات كموقف أرسطو من أستاذه أفلاطون الذي كان، بالرغم من احترامه له، لا ينفكّ ينقد نظريّاته في المثل ونحوها نقدًا لا هوادة فيه، وزاد العرب كثيرًا على الفلسفة اليونانيّة حتّى أصبحت لهم فلسفة خاصّة مصدرها التراث، والفلسفة اليونانيّة، والنصوص الدينيّة، ونُسبت إليهم، فيقال فلسفة الكندي، وفلسفة الفارابي، وفلسفة ابن سينا، وفلسفة الغزالي وفلسفة ابن رشد، ولكلّ من هذه الفلسفات مواصفات تميّزها عن الأخرى، فظهر على بعضها المسحة العقلانيّة، وعلى بعضها الآخر المسحة الدينيّة، وكِلا الفريقيْن يتفقّ والفلسفة اليونانيّة في كثير من النظريّات، ويخالفها في كثير غيرها.
كلّ هذا كان يعرفه مؤرّخو الفلسفة في الغرب، وله في سرّهم تقدير عظيم، لكنّهم لا يظهرونه استكبارًا، لقد كان انعدام اهتمام الغرب بالفكر العربي كبيرًا جدًّا، ومن الأدلّة على اهتمامهم أنهم كانوا يبذلون في دراسته أقصى جهدهم لكي يأخذوا ما يأخذونه على بيّنة، ولكي يرفضوا ما يرفضونه على بيّنة، أذكر من ذلك الحملة الشعواء على فلسفة ابن رشد من لدن القديس توما الأكويني، وألبرت الكبير، وغليوم دافرني، وريمون لول لأنّهم رأوا بعضًا في نظريّاته لا يتّفق ورأي النصرانيّة كنظريّته المعقّدة في قدم الكون مثلاً، في حين أنّ جامعة بادو كانت ما برحت في أواسط القرن السابع عشر تدرِّس فلسفة ابن رشد وتنشر آراءه. كما أن دانتي، في الملهاة الإلهيّة جعل لابن رشد صورتيْن إحداهما الشارح العظيم لأرسطو، والثانية صورة الملحد الذي يتبوّأ، مركزه بهدوء ووقار في الجحيم مع غيره من العظماء، وهذا يدلّ، كما أشرت أعلاه، على أنّ فلاسفة العرب لم يكونوا في الغرب هملًا. أو شيئًا زهيدًا لا يُلتفت إليه. ويقول الدكتور جميل صليبا في تاريخه إنّ فلاسفة العرب جمعوا في ثقافتهم التيّارات الفكريّة المتعدِّدة، فجاءت فلسفتهم مشابهة للفلسفة اليونانيّة في أصولها ومبادئها، ومباينة لها في مقاصدها وغاياتها، فكأنّ ثمة نهريّن مؤلّفيْن من مياه واحدة، ويتّجهان في جريهما اتجاهيْن مختلفيْن.
فالقول بعدم وجود الفلسفة عند العرب من حيث الكلمة لغويَّا صحيح، وعدم وجودها عندهم بجسم سويٍّ متكامل بقواعده وأصوله لولا الفلسفة اليونانيّة، صحيح، وعدم وجود الفلسفة في الإسلام عند فريق من الفقهاء صحيح أيضًا لأنّهم رأوا فيها ما يناقض الدين، فاستبعدوها، بعضهم كلّيًّا مثل ابن الجوزي والمقريزي والسيوطي وابن تيميّة الذي اعترض على تسمية الكندي بفيلسوف الإسلام وقال: “ليس في الإسلام فلاسفة”، وبعضهم جزئيًّا مثل كثيرين من الفقهاء المسلمين. أمّا القول بأن العرب لا يعرفون الفكر الفلسفي، كما زعم بعض مؤرّخي الفلسفة الغربيين، فهو غير صحيح.
يقول الدكتور علي زيعور بهذا الموضوع ما معناه: إن المتغلِّب سلب إرادتنا مرّة من الزمن، ووضعنا في موقف غير متّزن، وحملنا على الإعجاب والانفعال بالغرب، فتقبّلنا كلّ ما أراد الغربي أن يولّد فينا من استصغار لقيَمنا الفكريّة، والنظر إلى الفلسفة على أنّها يونانيّة، أو أنها من نتاج أوروبا الحديثة، فأضعنا شخصيّتنا وبخسنا أنفسنا حقّها، وأقررنا بتفوّق الغربي علينا، فكنّا كالضحيّة التي تنحر نفسها بيديها.
قبل أن أفصل عن هذا القسم من البحث يجب أن أعترف بأنني انزلقت مع الغربيين إلى القول بفلسفة شرقيّة أو غربيّة أو يونانيّة أو عربيّة، والحقيقة أن الفلسفة واحدة، لا شرقيّة ولا عربيّة، بل هي نتاج عقل الإنسان، أينما كان، لفهم أسرار الكون، لكنّي رضيت بذلك موقنًا، كما يقول الدكتور زيعور، وإنّي، في كلّ حال، أقول إن الفلسفة إذا ما خصّصت، فقد كان للعرب فلسفة نُسبت إليهم، وتميّزت عن الفلسفة اليونانيّة، وإذا ما وحّدت، كما يجب أن تكون النظرة إليها، فإن العرب قد أسهموا فيها بقسط وافر في التأسيس وفي البيان.
ثالثا: أوروبا مدينة للشرق العربي وليس العكس
بقيت قضيّة مهمّة يجب أن أثيرها وهي أن أوروبا، المزدهيّة بالتراث اليوناني العريق، التي تعيد إليه وجده دون سواه حضارة العالم برمّتها، يجب أن تعلم، وهي لا شكّ عالمة، أن الشعلة اليونانيّة انطفأ وهجها، وخبا تألّقها، في نحو القرن الثاني قبل الميلاد، ولم تأخذ أوروبا شيئًا عنها قي ذلك الحين، بل بقيت تلهو بالتناحر والتقاتل، رازحة تحت وطأة الجهل والغباء والبدائيّة المتأخّرة.
والنهضة الأوروبيّة، التي تستحقّ الازدهاء، لم تبدأ إلّا في القرن السادس عشر الميلادي، عندما كان قد أصبح في أوروبا معظم الجامعات تعلّم اللغة العربيّة، وعندما تُرجمت كتب الفلاسفة العرب إلى اللغات الأوروبيّة فنقلت إليها علوم العرب وفلسفة اليونان، فأوروبا لم تأخذ شيئًا مباشرًا ممّا ندعوه المعجزة اليونانيّة وتزدهي به باطلًا، بل أخذت الحضارة اليونانيّة عن الترجمات العربيّة، ممزوجة بالفكر العربي، فضلًا عن أن كُتبًا كثيرة فُقد أصلها، فكان الفضل في معرفة مضمونها للترجمات العربيّة، أو للترجمات اللاتينيّة المنقولة عن العربية.
خاتمة:
في هذا البحث أمور ثلاثة لا أدّعي أنني رائد فيها، بل أنا موقظ ومنبّه على أمل أن أحد ذوي الاختصاص يأخذ هذه الهيكليّة التي أقدّمها هنا، فيكسوها لحمًا وجلدّا، وثيابًا أنيقة، ويخرجها كتابًا يكون فيه نفع لأساتذة تاريخ الفلسفة وطلّابهم وهذه الأمور هي التالية:
أولًا: المعجزة اليونانيّة هي معجزة لأنّها وضعت للفلسفة أصولًا وقواعد، لا لأنها أبدعتها.
ثانيًا: كان للعرب قبل الفلسفة اليونانيّة وفي زمانها، تفكير فلسفيّ يسمّونه حكمة أو ما أشبه ذلك، ثم استعانوا بالفلسفة اليونانيّة أحيانًا. فكوّنوا فلسفة عربيّة توافق الفلسفة اليونانيّة أحيانًا، وتخالفها أخرى، فتميّزت عنها، ونُسبت كلّ منها إلى صاحبها.
ثالثًا: كان للعرب فضل كبير على نهضة الثقافة الأوروبيّة عن طريق المخطوطات العربيّة التي تُرجمت، وعلّمتها جامعات أوروبا بدءًا من القرن الثالث عشر الميلادي، وعن طريق العلاقات، في حرب أو في سلم، مع العرب في إسبانيا والبرتغال وإيطاليا وصقليا وغيرها.
لقد أخذت أوروبا بالفلسفة اليونانيّة، فعبدت العقل، وأحبّت الحياة، وتعلّقت بالدنيا، لكنّ وجود اليهوديّة والنصرانيًة هناك، وآثار الإسلام في الشعب الأندلسي، حوّلت الأنظار فيها قليلًا إلى الفلسفة الشرقيّة، وهم لا يسمّونها كذلك استكبارًا وعنجهية، بل يقولون إلى فلسفة فيثاغوروس وأفلاطون وأفلوطين، وهل كانت فلسفة هؤلاء إلّا شرقيّة؟ ومع ذلك فإنها بعض من كلّ، لأنّ الله لا يسمح للإنسان بأن يفهم على الأرض جميع أسرار الكون، بل يرفع النقاب تدريجيًّا عن البصيرة الواعية، بقدر ما يصل إليه المرء من الصفاء، لكي ينير عقله الأسمى مناور الحكمة الإلهية.
كلمتي هذه لم تتّسع للدخول في التفاصيل، وما أردت منها أن تكون كذلك، لأن الأمر ليس من شأني، ولا الردّ على المؤرّخين الأوروبيين يهمّني، لكنّني أردت منها أن ألفت نظر أساتذة تاريخ الفلسفة في جامعاتنا، الضاربين على سنن المؤرّخين الغربيين الذين يدرّسون تاريخ الفلسفة ولا يدرّسون الفلسفة العربيّة، عامدين أو عن غير قصد، إلى ضرورة الاهتمام بوجهات النظر الثلاث التي قدّمتها في هذا البحث، وإذا لم يجدوا مقنعًا في البديهيّات التي ذكرتها، فليبحثوا عن الأسانيد، فإنّهم واجدون منها ما يفي بالمطلوب، وإنّي أزوّدهم بالمحبّة والدعاء، والسلام عليهم وعليكم أيها القارئ الكريم.
المصادر:
- مكتبة البحث
- تاريخ الفلسفة العربيّة للدكتور خليل الجر وحنا الفاخوري.
- تاريخ الفلسفة العربيّة للدكتور جميل صليبا.
- رصيد التاريخ لرينييه غروشيه ترجمة محمد خليل الباشا.
- الفلسفات الهنديّة للدكتور علي زيعور.
- الفلسفة في الشرق لبول ماسون اورسيل، ترجمة محمد يوسف موسى.
- التقمّص وأسرار الحياة أو الموت لمحمد خليل باشا
الدكتور محمد خليل باشا:
مثقّف من لبنان (1914-2009) وُلد في بلدة ديربابا. أنهى دراسته الثانويّة في الكليّة البطريركيّة في بيروت، والجامعيّة في معهد الآداب الشرقيّة في الكليّة اليسوعيّة وفي الجامعة الأمريكيّة. اشتغل معلِّما للغة الفرنسيّة في عدّة مدارس، ثمّ أنشأ شركة الاقتصاد الزراعي في بيروت، وتولّى إدارتها ورئاسة مجلس الإدارة فيها (1940 -1943) ثم عُيّن في مكتب الإحصاء والارتباط، وكُلِّف بتأسيس مكتب الإحصاء والارتباط الإقليمي في لبنان الجنوبي وعُيِّن رئيسًا له، ثم عُيِّن رئيساً في نفس الوظيفة في لبنان الشمالي، عُيِّن عام 1949 رئيسًا في وزارة التموين في بيروت ثم رئيسًا لديوان مراقبة الشركات ثم رئيس الوصاية الإداريّة على مصالح الاستثمار، ثم مديرًا لليانصيب الوطني اللبناني 1966 وأحيل على التقاعد عام 1980 برتبة مدير عام. ترشّح للنيابة عام 1964 وانسحب. له نشاط ثقافي مكثّف. نشر مقالات وألقى محاضرات واشترك بندوات ومقابلات. يحمل وسام الأرز الوطني من رتبة فارس وأوسمة أخرى. عضو فخري دائم في المجمع العلمي الأمريكي. مُنح دكتوراه فخريّة تقديرًا لأعماله. عضو اتحاد الكُتّاب اللبنانيين. عضو اتحاد الكُتّاب العرب. عضو جمعيّة أهل القلم. أقيمت له عدّة حفلات تقدير. ألّف عددًا كبيرًا من الكتب أهمّها: معجم أعلام الدروز، معجم المؤلِّفين، التقمُّص وأسرار الحياة والموت، الإنسان وتقلُّبه في الآفاق وغيرها. (عن: موسوعة التوحيد الدرزية)